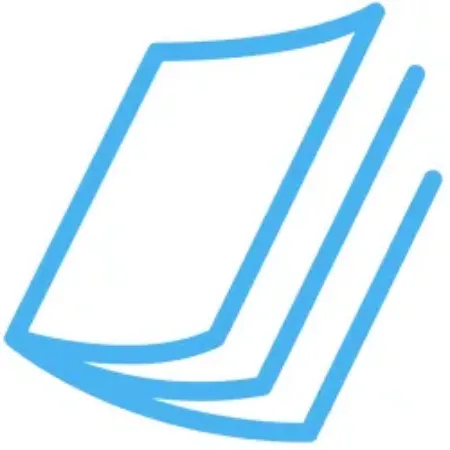لا يوجد منتجات فى سلة التسوق
تصفية حسب الشركة الموزعة
ادب
حي 14 تموز - سهيل سامي نادر - المدى
في أوائل شهر شباط من عام 2006، وقبل مغادرتي العراق بأيام، زارني في بيتي شاب نحيل مُصاب بعرج ولادي بصحبة أخي الأصغر الذي يسكن بشقة تحت شقتي. استغربت هذه الزيارة نظراً لأجواء الحرب الأهلية التي سادت بعد تفجير سامراء، وبقاء الجميع في بيوتهم. طمأنني أخي أن الشاب صديقه ويسكن في حيّنا على مبعدة قليلة من بيتي.ابتسم الزائر ابتسامة خجولة وقال: كتبت نصف رواية أو ما أعتقد أنها رواية، أنتَ مفتاحها الأول
9.000د 7.500د
حي الميدان في العصر العثماني - بريجيت مارينو - المدى
16.500د 15.000د
حياة البيروني - محمد عبد الحميد الحمد - المدى
12.000د 10.500د
حياة صريحة الكتاب للجميع - سعدي يوسف - المدى
4.500د 3.000د
حياة صريحة ج4 سعدي يوسف الاعمال الشعرية - سعدي يوسف - المدى
16.500د 15.000د
حياة غراند كوبلاند الثالثة - اليس ووكر - ترجمة سيزار كبيبو - المدى
في مجتمع يبدو فيه كل شيء قابلاً للتمدد والتوسع، ما الذي يمكن أن نبجّله ونحميه ببذل الغالي والرخيص وندفع حياتنا ثمناً له؟ أميل للاعتقاد، ومع الأسف، إلى أنه ثمّة تقدير عظيم لقيمة الروح في مجتمع السود في الماضي أكثر من الآن، لقد أصبحنا نشبه مضطهدينا إلى حدٍ بعيد، نشبههم لدرجة تفوق طاقتنا على الإقرار بذلك. لطالما ردد أسلافنا تعبير «إن روحه ملكه» لوصف شخص ذي مكانة، وكان لهذا معنى ووقْع ودلالة. امتلاك المال لا يشبه امتلاك السلطة ولا الشهرة ولا حتى «الحرية»، هذه الكلمات غير متشابهة على الإطلاق. وبوصفي الابنة الحتمية للناس الذين ترعرعت على أيديهم وأرشدوني ولمست فيهم أفضل الخصال وأسوأها، أؤمن من كل قلبي بضرورة المحافظة على الفضاء الداخلي مصاناً بالكامل، الفضاء الموهوب للجميع. أؤمن بالروح. وأكثر من ذلك، أؤمن أنها تحاسب المرء فورياً على خياراته، إنها قبول طوعي لمسؤولية المرء عن أفكاره وسلوكه وأفعاله، وهنا مكمن قوتها. اضطهاد الرجل الأبيض لي لن يكون أبداً شمّاعة وذريعة أتحصن بها لاضطهاد غيري، سواء كان رجلًا أم امرأة أم طفلاً أم حيواناً أم شجرة، لأن الذات التي فزت بها تأنف أن تكون ملكاً له، أو لغيره. ثمّة أشخاص لا يمكن لهم أن يكونوا عبيداً قط، الكثير من أسلافنا العبيد كانوا غير عبيد. هذا جزء من اللغز والهبة التي ورثناها وأسهمت في حثنا على الصمود ومواصلة الطريق، لنسير على الدرب ذاته جيلًا بعد جيل. هذا هو الفهم الذي يحل أحجية وشيفرة حياة «الأرواح الناجية» في هذه الرواية، حياة غرانغ كوبالند وحفيدته روث. إنها فهم لإمكانية مقاومة الهيمنة، فهمٌ يمكن لجميع الناس تبنّيه. سألت غرانغ خلال إحدى السهرات: «هل تعتقد أن مساعيه ستثمر؟»، مشيرة إلى عيني الدكتور كينغ المنهكتين الشرقيتين، اللتين ظهرتا عبر الشاشة باردتين وخاليتين من أي عمق. قال غرانغ: «كنت لأتفاءل أكثر لو ثّمة بارقة أمل في أن يصير رئيس البلاد يوماً ما. يقيني باستحالة ذلك يخفف من حلاوة مشاهدته. إنه رجل بحق»، واستطرد قائلًا: «بالطبع، لو كنت مكانه لتصرفت بطريقة مختلفة وقدّرت نفسي حق تقدير، لكني لا أولي نفسي الاهتمام اللازم، وجّل ما أفعله الجلوس في هذا المكان الرتيب، لذا لا يحق لي فتح فمي والتشدق وإسداء النصائح. أكثر شيء يلفتني به هو أنه برغم تحقير البيض له، فإنه يتعامل بنبلٍ مع زوجته وأطفاله»
16.500د 15.000د
حيث الظهيرة في برجها - راسم المدهون - المدى
4.500د 3.000د
حيث لاينبت النخيل - عبد الكريم هداد - المدى
حيث لاينبت النخيل.....تلك هي المدينة تلك هي الاناشيد، ديوان شعر للشاعر عبدالكريم هداد ،
6.000د 4.500د
حيث هو القلب - صادق الصايغ - المدى
3.000د 1.500د
حين تتشابك الحكايا - سلوى جراح - المدى
أنهت حكايتها. أحس أن كل ما يمكن أن يقوله سيكون بلا معنى. الشيء الوحيد الذي كان يمكن أن يقوله هو أنه غارق في حبها. لكن شجاعته خانته. خاف أن يبدو كنهّازِ للفرص، فالحب قد يملي الكثير من الانتهازية في لحظات ضعف من نحب. لم يفكر حتى أن يسألها عن تفاصيل ما حدث بعد ذلك، كيف كانت ردود فعل كل من لهم علاقة بهما؟ كل ما كان يشغله في تلك اللحظة، أنه يحب هذه المرأة التي تروي له قصة حبها لرجل آخر. وجد نفسه يتساءل، هل يمكن أن تحبه كما أحبت حبيبها الأول؟ تحايل على نفسه بمقولة أن الحب لا يتكرر بنفس التفاصيل لأنه كالنهر يتغير باستمرار. رغم ذلك، أحس بشيء من الغيرة من ذاك الحب الذي عاشته في سنين شبابها المبكر، حبها الأول الذي ملأ دنياها وانتهى نهاية درامية تصلح لأن تكون فيلماً سينمائياً من زمن الأبيض والاسود. حاول أن يتخيل ذاك الحبيب الذي مات وتركها في حزن تلّبسها لسنين، وجعلها ترفض فكرة الارتباط برجل غيره، وصارت أمها تقول لها كلما رفضت عريساً: «على كيفك يمه. شو بدي أقول، بكرة لما يجي نصيبك رح ترضي وعلى رأي المثل، خلي العسل بجراره لتيجي أسعاره.»
7.500د 6.000د