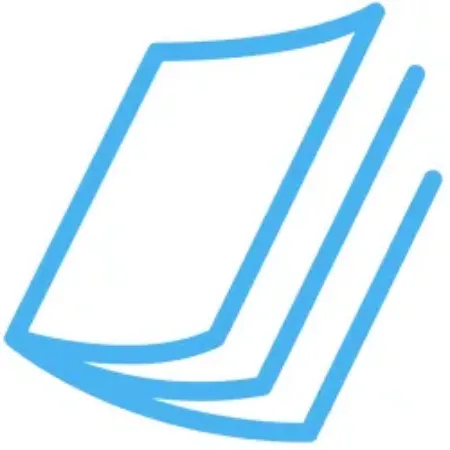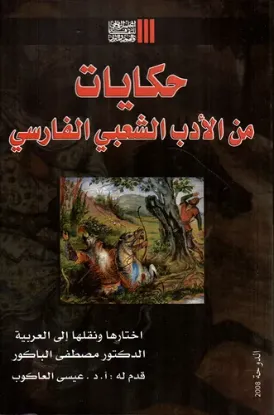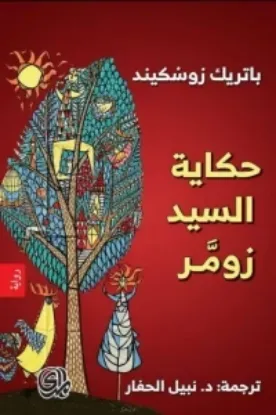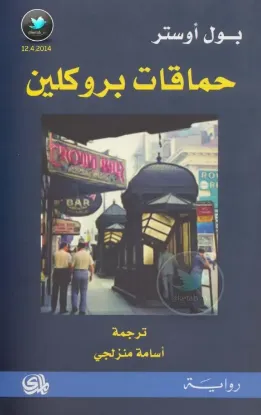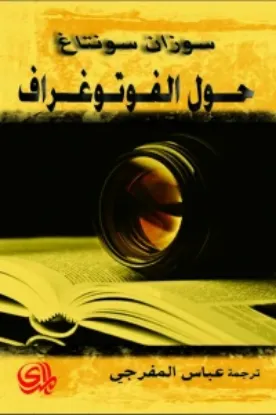لا يوجد منتجات فى سلة التسوق
تصفية حسب الشركة الموزعة
ادب
حكايات من الادب الشعبي الفارسي - مجموعة من المؤلفين - ترجمة مصطفى الباكور - المدى
هذا الكتاب دعوة للإبحار في فن القصص الفارسية حيث تمتزج الأسطورة بالحكمة والفتوة والخصال الحميدة. جامع هذا الكتاب وناقله عن الفارسية هو الدكتور مصطفى البكور الباحث السوري في الدراسات الفارسية. يفتتح الكاتب عمله في المقدمة بمقولة للحكيم أبي القاسم الفردوسي 330-416هـ. تتعلق بالقصص والحكمة من ورائها: لا تظن هذه القصص كذباً وخرافة أو مصبوغاً بالسحر والأعذار: فكل ما تعارض مع العقل، أمكن حمله على سبيل الرمز. ولم يرد ذكر الفردوسي على سبيل المصادفة، لأن مجمل الحكايات الشعبية المنقولة ليست إلا مجموعة من تصورات الناس ورؤاهم الفكرية الحاصلة من خلال تفاعلهم الطويل مع شاهنامة الفردوسي الشهيرة في الأدب الفارسي والمترجمة إلى لغات العالم. وجدير بالذكر إن شاهنامة الفردوسي التي ألفها الفيلسوف الحكيم من سنة 370-402هـ. تعرض لخمسين ملكاً يمتدون على طول أربعة سلاسل ملكية ووفق ثلاثة مراحل هي: المرحلة الأسطورية، ثم البطولية، فالحماسية. كما يؤمل أن يكون الاهتمام بالثقافة الفارسية رداً مهذباً على كتابات بعض الإيرانيين المتغربين الذين يتنافسون في الإساءة إلى الثقافة العربية ويؤرثون الأحقاد القديمة.
10.500د 9.000د
حكايات من فضل الله عثمان - ابراهيم اصلان - المدى
4.500د 3.000د
حكاية السيد زومر - باتريك زوسكيند - ترجمة نبيل الحفار - المدى
في ذلك الوقت، عندما كنت لا أزال أتسلق الأشجار – وهذا منذ زمن بعيد، بعيد جداً، قبل سنوات وعقود كثيرة، حينها كان طولي لا يتجاوز المتر إلا قليلاً، وقياس قدمي ثمانية وعشرين، وكنت خفيفاً لدرجة أنه كان بوسعي الطيران – لا، هذا ليس كذباً، فقد كان بوسعي حقاً أن أطير آنذاك – أو تقريباً على الأقل، أو يُفضل أن أقول: يُحتمل حقاً أنه كان بإمكاني حينذاك أن أطير، لو أني عندها قد أردت ذلك فعلاً وبإصرار، ولو أني حاولت حقاً، إذ... إذ ما زلت أذكر تماماً، أني ذات مرة كنت على وشك أن أطير. كان ذلك في الخريف، في سنتي المدرسية الأولى. كنت عائداً من المدرسة إلى البيت وكانت تهب ريح بالغة الشدة، لحد أنه كان بمقدوري دون أن أفرد ذراعيَّ، أن أميل عليها، مثل القافزين من على منصة الثلج بل وأكثر، دون أن أقع... وعندما ركضت في وجه الريح عبرالمروج منحدراً على جبل المدرسة – إذ كانت المدرسة مبنية فوق جبل صغير خارج محيط القرية – وأنا أقفزعن الأرض قليلاً، فارداً ذراعي، رفعتني الريح، فصار بوسعي القفز دونما جهد لارتفاع مترين وثلاثة وأن أخطو مسافة عشرة أمتار بل اثني عشر متراً ـ ربما ليس بهذا الارتفاع ولا بهذا الطول، وما الفرق في ذلك –!.
7.500د 6.000د
حكمة البحر - ياسين طه حافظ - المدى
حين أواجِهُ موتَ الورقة، أتوقّفُ، ثم أبدأ بإزاحَةِ بياضها غير مطمئنٍ على استحقاق ما أسكبُه عليها، فأنا أُرقِّشُها برسوم مشوّهة وطوارئِ أفكار. لا أدري تماماً، لكنّي أُخمِّن أني أشعرُ بما هو قابل للنسيان، فألْتَقِفُهُ وهو يترك أثراً على يدَيَّ وظلالاً على الورقة. استمرُّ مفترضاً أننا نبدأ كلَّ شيءٍ بأخطائنا. وما أُريدهُ لا تُسعفُهُ الكلمات إلا قَدْرَ التنفّس. أُحسُّ اعتراضاتهِ، صيحاتِ الرفض في رأسي تُرعشُ يدي وتوقف القلم، يتحركُ وتوقفُه! أقل
9.000د 7.500د
حكمة الروح الصوفي - ميثم الجنابي - المدى
16.500د 15.000د
حليب مراق - ساره ماواير - ترجمة سعدي يوسف - المدى
5.250د 3.750د
حماقات بروكلين - بول اوستر - ترجمة اسامة منزلجي - المدى
تُ أفتش عن موضع هادئ أموت فيه أوصاني أحدهم باللجوء إلى بروكلين ، وفي صبيحة اليوم اللاحق سافرت إلى ثمة من ويستشستر لأستطلع المكان . لم أكن قد عدت إليها منذ ستة وخمسين عاماً وقتما كنت في الثالثة ، ولم أتذكر أي شيء . كان والداي قد رحلا عن البلدة وأنا في الثالثة من السن ، لكنني وجدت نفسي غريزياً أعود إلى الحي الذي عاشا فيه ، زاحفاً إلى الوطن ككلب مصاب إذ مسقط رأسي . قادني واحد من وكلاء المنشآت وُجلنا في أرجاء الموضع وزرنا الوحدات السكنية الست أو السبع المبنية بالصخر الأسمر ، ومع آخر اليوم كنت قد استأجرت سكن تتضمن غرفتي غفو وتحيط بها حديقة في الشارع الأضخم بجوار حديقة بروسبكت العامة
24.000د 22.500د
حنين - احمد البحيري - المدى
6.000د 4.500د
حوار الامم - محمد عبد الحميد الحمد - المدى
15.000د 13.500د
حوار الشرفات الصامت - رياض بيدس - المدى
6.750د 5.250د
حول الفوتوغراف - سوزان سونتاج - ترجمة عباس المفرجي - المدى
يطرح النقد الخلاّق لسوزان سونتاغ عن التصوير الفوتوغرافي أسئلة فعّالة حول القضايا الجمالية والأخلاقية التي تخص هذا الشكل من الفن. الصور الفوتوغرافية هي في كل مكان. لها القدرة على الصدمة، على جعل الأشياء مثالية أو مغوية، وهي تولّد شعورا بالحنين، وهي بمثابة تذكارات، ويمكن أن تُستخدَم كبرهان ضدنا أو تعي ّن شخصيتنا. هنا، تتحرّى سونتاغ الطرق التي تُستعمَل بها هذه الصور كلية الوجود في إختلاق إحساساً بالواقع والنفوذ في حياتنا.
12.000د 10.500د